في يوم المرأة: صورة المرأة الفلسطينية في الواقع الراهن (ج1) / غازي الصوراني
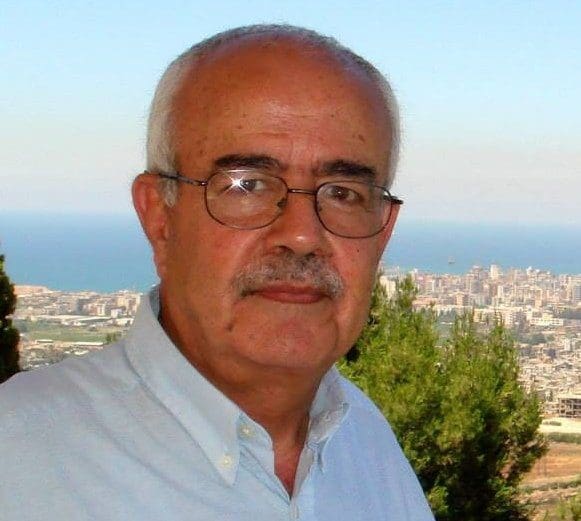
- إن وضوح العوامل والأسباب الموضوعية (الاجتماعية والاقتصادية والثقافية) لأزمة المرأة في بلادنا، لا يلغي خصوصية وضعها، أو العوامل الذاتية المتراكمة في إطار الجهل والتخلف والفقر ، والجذور التاريخية الموروثة، التي جعلت من النساء عموماً ، وفي الأوساط الشعبية الفقيرة خصوصاً ، في حالة من الخضوع الذاتي للرجل، بصورة عفوية، تتطابق مع خضوعها للعادات والتقاليد والأعراف الموروثة في النظام الأبوي باعتبارها " قدر" لا يجوز رفضه أو الاعتراض عليه، بل على العكس تدافع عنه وتؤكد عليه وتتبنى مفاهيمه وقيمه .
إن المقصود بالصورة هنا، هو طبيعة التركيبة الذهنية للمرأة، بما تحتويه من عناصر ومكونات موضوعية وذاتية ، خضعت وتخضع لسياقات اجتماعية وتاريخية معينة. إذ أن هذه التركيبة هي الآلية المستقلة أو الفاعلة بمقتضى عوامل متراكمة تاريخية ومعاصرة ، بواسطة جملة من الأدوات التواصلية كاللغة والدين والقانون والثقافة بمختلف مكوّناتها… ولكن هذه الأدوات لا تؤدّي وظائفها بمعزل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل أساس البناء الاجتماعي لهذه التركيبة / الصورة التي لم تتطور مكوناتها بشكل جوهري أو متمايز عما كان عليه الحال في فلسطين قبل 50 عاماً ، فمازالت المرأة عندنا تأتمر بأوامر الرجل وتدخل عنوة وغصبا بيت الطاعة والخضوع، وتساهم بالتالي –وفق ما أسميه عفوية الرضوخ- في إعادة إنتاج مكانتها الدونية في المجتمع.
وفيما بعد هزيمة حزيران 1967، قام الاحتلال بالمحافظة على مجمل العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحطّ من قيمة المرأة وتمنع تحرّرها، لكن قوة انتشار وتأثير حركات المقاومة الفلسطينية ، ساهمت بصورة ملموسة في كسر الطبيعة المحافظة ، الرجعية للعديد من النساء، اللواتي التحقن في صفوف المقاومة عموماً، وفي فصائل وأحزاب اليسار خصوصاً، وكان للانتفاضة الأولى 1987 دوراً هاماً في تطوير دور المرأة السياسي والاجتماعي، حيث أتاحت مساحة واسعة لها في المشاركة في النضال ضد الاحتلال حتى عام 1994، حيث بدأ مسار الانتفاضة في التراجع لحساب عملية التفاوض وصولاً إلى أوسلو 1993، ثم قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، التي أسهمت بدورها في بعض الجوانب التطورية الخاصة بالمرأة عبر عدد من الأنظمة والقوانين ، ولكن بالرغم من ذلك، بقيت أسباب العنف المسلط على النساء قائمة بسبب بقاء البنى الاقتصادية الاجتماعية والعائلية التقليدية التي قامت السلطة بتغذيتها –خاصة في قطاع غزة في ظل الانقسام- لحساب ذهنية التخلف التي عززت بقاء جذور العنف على حالها، سواء في ظل العلاقات الرأسمالية التابعة والمشوهة في قطاع غزة من ناحية أو في إطار نفس العلاقات الرأسمالية المشوهة في مدن الضفة، إلى جانب الاقتصاد الفلاحي في قرى الضفة الذي تحكمه علاقات إنتاج ما قبل رأسمالية ، حيث يبرز في الحالتين تفاوتا اجتماعياً واضحاً في أسلوب أو منهجية العلاقة مع المرأة أو ما يعرف بالريف والمدينة ، كلاهما محكومان – بأشكال مختلفة – بعلاقات ذكورية قائمة على استغلال واضطهاد المرأة من منظور متخلف ينطلق بداية من دونيتها والحط من قيمتها ويحول دون تحررها الذاتي والاجتماعي من جهة، وعلى الرغم من أن المرأة الفلسطينية أسهمت عبر مشاركتها في مسيرة النضال الفلسطيني من 1967 حتى اللحظة بدور طليعي وطني وثوري متميز حيث دخل الجسون حوالي (15) ألف امراة .
وفي هذا السياق ، أشير إلى أن كل ما يذكر حول المرأة في الأطر القانونية والمؤسساتية، لا يعدو أن يكون سوى اطاراً نظريا تستخدمه السلطة من أجل التعتيم الديماغوجي، وحجب الواقع الفعلي الذي تعيشه المرأة. علماً بأن هذا التشريع جاء تلبية لمطالب القوى الديمقراطية اليسارية والحركات النسائية التي تناضل من أجل حرية المرأة وتحريرها من قيود الاستغلال والاستبداد وضرورة مساواتها مع الرجل.
ولكن هذه الأنظمة والقوانين ينقصها التطبيق في مستوى الممارسة اليومية. إذ أن أغلبية الشكاوى يقع حسمها في مراكز الشرطة دون المرور بالمحكمة، أو تتنازل المرأة عن حقها في الدفاع عن نفسها وردّ الاعتبار لذاتها المسلوبة وذلك تحت ضغط العلاقات الإجتماعية القرابية وأيضا تحت ضغط التقاليد الاجتماعية باسم “التسامح “. ممّا يضيع حقّها عبر التسامح السلبي، كما أن العديد من مشاكل العنف تقع تسويتها في حدود “البيت” أو العائلة أو بعض الهيئات الدينية والعلاقات العشائرية… الشيء الذي يؤكّد ما قاله لينين من أن “المساواة في القانون لا تعني المساواة في الحياة“.
إن طرحنا لهذه الخصوصية المرتبطة بقضية المرأة في بلادنا ، يستهدف التصدي لهذه النظرة الموروثة المستقرة حتى الآن في الذاكرة الجمعية لمجتمعنا ، كامتداد لاستقرارها في العلاقات الاجتماعية و العادات و التقاليد و الأعراف والثقافات التراثية[1] الموروثة المشوهة، التي تتجدد يومياً عبر وسائل الاعلام والمنابر والندوات الدينية والفضائيات، في سياق عملية إعادة إنتاج التخلف ، ودورها في تكريس ومفاقمة الأزمة الراهنة في بلادنا ، بما يجعل من التصدي لكل هذه العوامل الموروثة السالبة قضية ترتبط أولاً و أخيراً بالتصدي لكل مظاهر وأدوات التبعية والتخلف والقهر، بكل أبعادها السياسية والمعرفية والاقتصادية والاجتماعية.
وبالتالي فإن أي حديث عن خصوصية المرأة ، أو قضاياها بمعزل عن هذه المظاهر، لا يرتقي في أحسن الأحوال إلا إلى شكل من أشكال الترميم السطحي أو الشكلي لبنيان مهترئ ، فالعمل الإصلاحي لا يحل القضايا الأساسية المتعلقة بحرية المرأة ، و لا يحقق لها المساواة في الحقوق المدنية و الاجتماعية ، بالضبط كما هو العمل الخيري أو الإغاثي – السائد اليوم في قطاع غزة بصورة خاصة – يظل عملاً هامشياً، غير أساسي ، لن يقضي على الفقر و الحاجة، كما لن يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي أو في تعزيز الصمود و المقاومة، بقدر ما يسهم في خلق القيم السالبة ، وتكريس الاعتماد على الآخر، بغض النظر عن أهدافه ودوافعه ، التي نادراً ما تكون متطابقة أو متقاطعة مع أهداف شعبنا، الوطنية ، التحررية والديمقراطية، الأمر الذي يفرض علينا، في سياق الحديث عن تحرر المرأة ومستقبلها في بلادنا ، مواجهة أزمة مجتمعنا الفلسطيني، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتراثية –كجزء من المجتمع العربي-، وتفكيك وإزالة العوامل التي تؤدي إلى تكريسها ، انطلاقاً من أن الخصم الأول للمرأة، هو المجتمع بأغلاله وقيوده وتخلفه وليس الرجل أباً أو أخاً أو زوجاً ، فالتحرر الحقيقي للمرأة هو التحرر من الاضطهاد الاجتماعي والاقتصادي، بمساواتها بالرجل في نظام ديمقراطي حديث، وهذا التحرر للمرأة، يفترض البحث عن وسائل جديدة تضمن تطوير دورها وإسهامها الفعال ، المساوي لإسهام الرجل ، في مسار النضال السياسي والاجتماعي الديمقراطي، وهذا يعني أن النضال من أجل الارتقاء بدور المرأة، لا يجب أن يتوقف أو أن ينحصر في قضايا اللحظة الراهنة، بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية فحسب، بل يجب أن يتخطى ذلك صوب الأصل، ونقصد بذلك طبيعة التطور الاجتماعي المشوه والمحتجز في بلادنا، ودور القوى التقدمية في مجابهة التخلف والارتقاء بقضايا المرأة الفلسطينية، فالمجتمع الفلسطيني – كما هو حال المجتمع العربي- مجتمع غير متبلور، أو في حالة سيولة طبقية، متخلف تابع مشوه، يجدد التخلف في إطار العلاقات الرأسمالية التابعة ، الرثة ، التي تعيد إنتاج النظام الأبوي ، ونظام القهر والاستغلال الطبقي الذي يحمل في طياته أبشع مظاهر الاضطهاد والاستغلال للمرأة، من حيث عدم مساواتها في البيت أو المدرسة مع أخوانها من الذكور ، أو في العلاقة مع زوجها ، حيث يتحدد وجودها وهويتها الاجتماعية، عبر شطب وجودها المستقل أو المتميز ، ويتم التعامل معها بكونها زوجة فلان ، والأمر كذلك مع والدها أو ابنها حيث يقال بأنها بنت فلان أو أم فلان، إلى جانب حرمانها من المشاركة الندية في أية حوارات عائلية ، أو مجتمعية ، ناهيكم عن رفض الاعتراف بشهادتها في موازاة شهادة الرجل في المحاكم.
إن هذه الممارسات جعلت المرأة – في بلادنا – شخصية مستلبة ، محكومة بشخصية الرجل ، ومندمجة إكراهياً في ذاته أو شخصه ، بما أدى – تاريخياً وراهناً – إلى فقدان الأغلبية الساحقة من النساء ، للقدرة على التعبير عن ذواتهن أو إراداتهن طالما بقيت أوضاع ومظاهر التخلف قائمة، وقابلة للانتشار والتراكم والتجدد في ظل نظام طبقي تابع، لا يلغي إرادة المرأة ودورها فحسب، بل يلغي أيضاً إرادة الرجل ويجعل منه عبداً لذلك النظام ، الأمر الذي يشجعه أو يسوغ له استعباد المرأة كنتيجة طبيعية لظروف القهر والفقر والتخلف من ناحية، وكنتيجة أيضاً لفقدان المرأة قدرتها أو فرصتها على تحقيق استقلالها الاقتصادي ومن ثم الاجتماعي من ناحية ثانية.
وفي كل الأحوال، فإن مظاهر الفقر والبطالة التي تنتشر بصورة متزايدة في بلادنا ، تدفع إلى تزايد حدة تدهور أوضاع المرأة بحيث تصبح وعاءاً يُفَرِّغ فيه الرجل كل أشكال الاضطهاد والظلم الطبقي الذي يتعرض له، بحيث يمكن القول بحق، أن المرأة عندنا تتعرض لكل أشكال استغلال والظلم والاضطهاد المجتمعي والطبقي والعائلي ، بحيث يمكن وصفها فعلاً بأنها مضطهدة المضطهدين ، خاصة مع تفاقم أوضاع الهزيمة والإفقار ، والانتشار غير المسبوق للتيارات الدينية أو ظاهرة الإسلام السياسي، التي لم يكن ممكناً ظهورها بهذا الاتساع، لولا تعمق مظاهر التبعية والتخلف والخضوع عبر الأنظمة الحاكمة، التي وفرت –عبر استبدادها وإفقار شعوبها- كافة الفرص والظروف الملائمة لانتشار التيارات الأصولية الرجعية، التي “ارتفعت راياتها” وعلت أصوات شخوصها في الأوضاع العربية المأزومة والمهزومة الراهنة، حيث انتشرت الفضائيات الناطقة باسمها، علماً بأن أحداً لم يسمع منهم موقفاً يدعو إلى مقاومة الاحتلال الصهيوني بعد حزيران 1967 حتى عام 1987، أو الدعوة لمقاومة الهجمة الإمبريالية الأمريكية على العراق أو إدانة مواقف دول الخليج والسعودية، وسياساتها الخاضعة للشروط الأمريكية ، واكتفوا برفع أصواتهم بالدعوة إلى إعادة إنتاج الأصوليات القديمة الشكلانية، المرتبطة بالاستبداد والقهر ورفض مفاهيم العقل والعلم والتنوير والوطنية والقومية لحساب ما يسمى بـ “الأمة الإسلامية” أو ” الخلافة العثمانية ” البائدة، إلى جانب ممارسة أشكال الإرهاب –المباشر وغير المباشر- ضد أي مظهر حضاري ينسجم مع حرية المرأة أو يعزز دورها الطليعي في المجتمع ، والتركيز على ارتداءها النقاب والحجاب ، والدعوة إلى إطلاق اللحى ولبس الجلباب القصير للرجال ، واستيراد ملابس الجلاليب والسبح والمسواك والتحف “الدينية”، وآلاف الكتب التي تتحدث عن “تفسير الأحلام” و ” عذاب القبور” وغير ذلك من العناوين التي تطال معظم الجوانب – الحياتية من وجهة نظر غيبية لا علاقة للدين بها…. إلخ ، إلى أخر هذه المظاهر الشكلية .
العوامل الموضوعية والذاتية لأزمة المرأة
إن وضوح العوامل والأسباب الموضوعية (الاجتماعية والاقتصادية والثقافية) لأزمة المرأة في بلادنا، لا يلغي خصوصية وضعها، أو العوامل الذاتية المتراكمة في إطار الجهل والتخلف والفقر ، والجذور التاريخية الموروثة، التي جعلت من النساء عموماً ، وفي الأوساط الشعبية الفقيرة خصوصاً ، في حالة من الخضوع الذاتي للرجل، بصورة عفوية، تتطابق مع خضوعها للعادات والتقاليد والأعراف الموروثة في النظام الأبوي باعتبارها ” قدر” لا يجوز رفضه أو الاعتراض عليه، بل على العكس تدافع عنه وتؤكد عليه وتتبنى مفاهيمه وقيمه .
فعلى الرغم من أن المراة العربية والفلسطينية ، – تمثل عددياً نصف المجتمع بشكل عام، إلا أنها ما تزال تعيش وفق منطق السيطرة والقمع الذكوري، الأمر الذي أدى – ويؤدي – إلى إنتاج العديد من المشكلات الاجتماعية المتنوعة، التي لا يمكن تجاوزها إلا من خلال تحقيق التحرر الذاتي للمرأة الذي يشمل التحرر الاقتصادي والسياسي.. إلخ.
فالتحرر الحقيقي للمرأة إذن ، الذي يوفر الضمانات الفعلية ، القانونية والمجتمعية للمرأة في اتخاذ القرار في كل الميادين و على كل المستويات ، و المشاركة في الأنشطة السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و الأسرية ، هذا هو التعبير عن حقيقة الارتباط الوثيق بين قضايا المرأة الفلسطينية و قضايا مجتمعها في الاستقلال الوطني و النهوض و التقدم الاجتماعي و التنمية و العدالة الاجتماعية و الديمقراطية بالالتحام العضوي بالحامل القومي العربي من حولنا ، و هي قضية يتحمل مسؤوليتها الأحزاب والفصائل اليسارية عموماً ، والطليعة الديمقراطية المثقفة –داخل تلك الأحزاب- من الرجال والنساء على حد سواء خصوصاً، لأن مواجهة جوهر الأزمة الراهنة ، بكل مظاهر التخلف و التبعية و الجهل و الاستبداد و القهر ، إلى جانب الفقر و سوء توزيع الثروة و غياب العدالة الاجتماعية ، يحتم هذا الترابط الجدلي الفعال بين السياسة و الاقتصاد ، أو بين التحرر الوطني و القومي من جهة ، و التحرر الديمقراطي المجتمعي الداخلي من جهة أخرى.
إذن وفي سياق حديثنا عن قضية المرأة في بلادنا ، فإن التحرر الاقتصادي شرط أولي لكل تحرر مادي أو معنوي ، اجتماعي أو سياسي أو غير ذلك ، وهنا تتبدى أهمية العمل بالنسبة للمرأة المعزز بالشهادة العلمية كشرط أساسي لعملية تحررها في سياق العمل ، إذ أن العمل المجرد الذي يتيح دخول أعداد كبيرة من نساء الطبقات الشعبية الكادحة إلى سوق العمل المأجور ، لا يوفر سوى شكل من أشكال التحرر الجزئي الاقتصادي ، وهي ظاهرة معروفة في بلادنا ، بحيث تبقى المرأة خاضعة لشروط الاضطهاد والخضوع الاجتماعي داخل الأسرة وخارجها ، خاصة وأن طبيعة التطور المشوه في مجتمعنا ، وتعدد أنماطه ، وتباينها في القرية عن المدينة عن المخيم عن المناطق الفقيرة من حيث العلاقة والموقف من المرأة ، رغم شكلية هذه التباينات، التي تتوافق في النهاية أو الجوهر، مع طبيعة البنية الذكورية للمجتمع، التي لا تقبل الاختلاف أو التعدد في الرأي أو النقاش الحر المفتوح إلا في حالات استثنائية ، والمفارقة ان العدد الأكبر من جماهير النساء في بلادنا –يقبلن بهذه الذكورية في ظل استمرار غياب شعور المرأة بذاتها بصورة واضحة ، بل وتتحمل –بصورة طوعية أحيانا لاعتبارات دينية أو تراثية- النصيب الأكبر من هذا التفرد والاستبداد الذكوري .
ولكي لا نساق إلى التحليل غير العلمي ، الذي يكتفي بظواهر الأشياء كحقائق فعلية للواقع بعيدا عن جوهره ، نعيد التأكيد على أن الخصم الأول للمرأة هو المجتمع التقليدي المتخلف، حيث يبرز في كثير من الحالات أو أشكال التعامل كخصم في ظرف محدد- فالمجتمع، كسبب أولي و رئيسي ، هو الذي يميز بين الطفل الذكر منذ صغره عن أخته، التي تتعلم أو تتشرب الرضوخ لأخيها، و للجنس المذكر عموماً منذ نعومة أظفارها ، إذن فالرجل كجنس ليس مسؤولاً عن اضطهاد المرأة ، بدليل أنه يتعرض للإستغلال و الإضطهاد أيضاً و هذا بدوره يدفعه إلى اضطهاد المرأة في ظروف القهر و الفقر و التخلف المشترك لكل منهما ، و هو اضطهاد مرفوض بالطبع بغض النظر عن دوافعه و أسبابه .
[1] على الرغم من أن تراثنا الثقافي والديني السلفي ، لا يخلو من بعض السلوكيات والمواقف الايجابية بالنسبة للتعامل مع المرأة ، إلا أن طبيعة التناقضات في الدولة الإسلامية بعد خلافة عمر بن الخطاب أدت إلى تجاهل وطمس النظرة الايجابية في التعامل مع المرأة ، وفي كل الأحوال فإن تلك المحطات أو الإشارات التي دافعت عن المرأة في التراث الإسلامي لم تكن سوى موقفاً أخلاقياً خجولاً ارتبط بعدد محدود ومتميز من النساء المقربات من الخليفة بحكم القرابة أو النسب أو المقربات من آل البيت وبالتالي لم يكن ذلك الموقف أصيلاً أو مبدئياً ينطبق على عامة النساء، أما في عصرنا الراهن فقد ازداد قهر المرأة بشاعة وعمقاً عبر الاستخدام المتخلف للثقافة السلفية ودعاتها المنتشرين اليوم في بلادنا من أجل إعادة “بناء” مجتمع إسلامي ذكوري يرفض التعاطي مع المرأة أو الإعتراف بأي دور لها .
